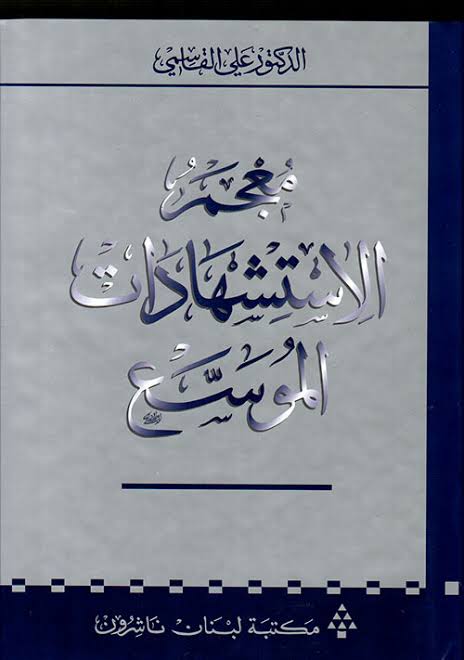الذين يمارسون الكتابة الأدبية في العالم العربي، لم يتعلَّموا أصول الكتابة الأدبية
تمهيد:
الدكتور علي القاسمي أديبٌ مفكرٌ عراقي متعدِّدُ الاهتمامات، يقيم في المغرب منذ قرابة خمسين عاماً. درس في جامعة بغداد، والجامعة الأمريكية في بيروت، وكلية الحقوق في جامعة بيروت العربية، وجامعة أوسلو، والسوربون في فرنسا، وأكسفورد في بريطانيا، وحصل على الدكتوراه من جامعة تكساس في أوستن، في تخصص علم المصطلح وصناعة المعجم.
ألَّفَ القاسمي أكثرَ من خمسين كتاباً في اللسانيات، والنقد، والرواية، والقصة، والترجمة، والتعليم العالي، وحقوق الإنسان، والتنمية البشرية؛ نُشِر معظمها في عدّة طبعات. وصدرَ أكثر من خمسين كتاباً ورسالةً جامعية عن مؤلَّفاته (تُنظر سيرته العلمية المختصرة المرفقة في آخر هذا الحوار).
يُعدُّ كتابه ” علم المصطلح: أُسسه النظرية وتطبيقاته العملية” (بيروت، 2019) الذي تقع طبعته الثانية في قرابة 900 صفحة، رائداً في الموضوع ويُدرَّ س في أغلبية الجامعات العربية، كما اكتسبَ كتابه بالإنجليزية، “علم اللغة وصناعة المعجم الثنائي اللغة“
“Linguistics and Bilingual Dictionaries الذي نشرته دار بريل في عدة طبعات، شهرة في مجاله بالجامعات العالمية.
يكتب القاسمي القصة والرواية بأسلوب حداثي، وقد نُشرت أعماله القصصية الكاملة في بيروت، وتُرجِمت روايته ” مرافئ الحب السبعة” إلى عددٍ من اللغات، وتقوم دارُ نشرٍ كبيرة في باريس حالياً بنشر ترجمتها إلى اللغة الفرنسية.
(يستطيع القارئ الكريم أن يطلع على كثير من أعمال القاسمي الأدبية في موقع “أصدقاء الدكتور علي القاسمي” في الشابكة).
حاورته: باسمة حامد
لست مغترباً في المغرب

المجلة الثقافية الجزائرية: في رصيدك الإبداعي محطات أكاديمية وإبداعية مهمة: (التدريس، الرواية، القصة، الترجمة، الدراسات، الفكر الإنساني، النقد الأدبي) وأمام هذه التجربة الغنية، أتساءل كيف ينظر علي قاسمي إلى نفسه اليوم كإنسان ومثقف مغترب منذ خمسين عاماً؟
د. علي القاسمي: شكراً على تكرُّم “مجلة الثقافة الجزائرية” بإجراء هذا الحوار معي. ويسعدني أن تكوني أنتِ مَن توجِّه الأسئلة. وجواباً على سؤلكِ الأوَّل، أقول إنني كنتُ وما أزال أَعُدُّ نفسي طالبَ علمٍ؛ أجدُ لذةً فيما أحصل عليه من معرفة، كمن يتناول طعاماً شهياً جيداً لم يذُقْهُ من قبل. وكوني أُقيم في بلدٍ ذي ثقافة عربية إسلامية عريقة، وأعيش مع شعب كريم أصيل نبيل، لا أعتبر نفسي مغترباً.
لا نقد من دون إبداع

المجلة الثقافية الجزائرية: الإبداع والنقد قضية إشكالية.. لكن برأيك أيهما أفضل للمبدع ليضمن تأثيراً أفضل لأفكاره: الإبداع خارج إطار القوانين والنظريات أم يتوجب عليه الأخذ بالحسبان تلك النظريات بشكل مسبق؟
د. علي القاسمي: لا نقد من دون إبداع. الإبداع أولاً، وقد يحصل الإبداع الجيد دون أن يحظى بالنقد، مدةً تقصر أو تطول. فـ “ملحمة جلجامش” التي دُوِّنت باللغة السومرية في الألف الرابع قبل الميلاد ولم يُعرَف اسم مؤلِّفها لحد الآن، لم يلتفت إليها النقّاد إلا بعد آلاف السنين من تدوينها.فالنص السومري الأصلي مفقود، وعُثِر على الملحمة مترجمة إلى اللغة البابليةالتي لم تُفكّ رموزها إلا قبل أكثر من قرن بقليل. وكذلك الملحمتان الإغريقيتان “الإلياذة“و “الأوديسة” اللتان ترويان أحداث حرب طرواد، وتُنسَبان للشاعر الأعمى هوميروس الذي يُحتمَل أنه عاش في القرن التاسع قبل الميلاد ويُشكُّ في وجوده أصلاً، لم يتطرق إليهما النقّاد إلا بعد بضعة قرون. وأيضاً الشعر العربي الجاهلي، لم يخضّع للنقد المنهجي إلا بعد قرون عديدة من نظمه أو إلقائه.
لا نقد من دون إبداع، فالنقد يقوم أساساً على الإبداع، ويأتي لكي يضيء جماليات النصّ، ويوقد فهم القارئ، ويشعل إمتاعه وفائدته.مع العلم أن في وسع كبار النقاد الانطلاق من نصٍّ محدَّد، وتأسيسَ نصٍّ جديد مستقلٍّ، وهذا نادرٌ.
المبدع والناقد، كلاهما،مطالبان باكتساب ثقافة واسعة عميقة قبل أن يتصديا للكتابة، التي تُعدّ أداةً رئيسةً في تثقيفِ المجتمع القارئ. فهما صاحبا رسالةٍ ترمي إلى تحقيق التنمية البشرية في بلادهما.ولهذا قال المؤلِّفون العرب القدماء: إذا أردت أن تكون عالماً فعليك أن تُلِّم تمام الإلمام بعلم واحد، أما إذا أردت أن تكون أديباً، فعليك أن تأخذ من كلِّ علمٍ بطرف. وبناء عليه، فإن من الضروري أن يطَّلع المبدع والناقد على النظريات الفلسفية والنقدية. ففي ذلك تعميق وتوسيع لعملهما. بيدَ أن التزام الأديب أو الناقد بنظرية نقديّة معينة، يضع حدوداً على إنتاجه، ويحدَّ من حرّيته. والحرية قوام الإبداع، أدباً ونقداً. ( للتوسع في الموضوع، يُنظَر كتابي ” الثورة والشعر”).
جمالُ اللغةِ وأساليبِها، يتغيّرُ من عصر إلى آخر

المجلة الثقافية الجزائرية: نلاحظ أن الكثير من النقاد يعبرون عن آرائهم بلغة جافة وربما متعالية أحياناً.. لكن من يقرأ مؤلفات د. علي القاسمي سيبحر في لغة نقدية جميلة تحمل المتعة والمعرفة في آن معاً.. هل تجد أن اللغة الجميلة أكثر تأثيرا في المتلقي؟
د. علي القاسمي: ــــسؤال متشعِّبٌ وخطير. فالجمال قضية نسبية، تتغيَّر وتتطوَّر من مكان ٍإلى آخر، ومن زمن إلى آخر. وغالباً ما نقول إن الجمال ذاتيٌّ ينبع من نفس الفرد وذوقه وميوله واحتياجاته، فالجمال ليس موضوعياً؛ لأنه لا يخضع لمقاييسَ محدَّدةٍ، وموازينَ مقنَّنةٍ. ولهذا قال الشاعر المهجري إيليا أبو ماضي:
والذي نفسُهُ بغير ِجمالٍ … لا يرى في الوجودٍ شيئاً جميلا
واللغة ذاتها، تتغيَّر وتتطوَّر وتنمو كلَّ يوم، نتيجةً لازدياد المعرفة وتكاثر المفاهيم. ففي كلِّ يومٍ تولدُ كلماتٌ، وتسبِتُ كلماتٌ، وتموت كلماتٌ. وفي كلِّ يوم تكتسبُ كلماتٌ معانٍ جديدة، وتسبتُ معانٍ أخرى وتنقرض معانٍ غيرها.
وجمالُ اللغةِ وأساليبِها، يتغيّرُ من عصر إلى آخر. ففي القرن الرابع الهجري (العاشر الميلادي)، مثلاً، كان الأسلوبُ المفضَّل في اللغة العربية هو أسلوب السجع والألفاظ المهجورة أو النادرة. واستمر هذا الأسلوب حتى القرن الميلادي التاسع عشر، أيام الثورة الصناعية وانتشار الصحافة في البلدان العربية، ما تطلَّب السرعة في الكتابة ويُسرها. ولم يعُد أسلوبُ السجع ملائماً لروح العصر. وتبدَّل الذوق العام، وأمسى النثر المسجوع أسلوباً غير مرحبٍ به، ويُحسَب متعالياً وعسيراً على الهضم والفهم.
ومع ذلك، فبالإضافة إلى الأسلوب الشائع في كل عصر، هنالك الأسلوب الشخصي. فلكلِّ كاتبٍ أسلوبه المميز في الكتابة، بناء على شخصيته وثقافته وخبراته وميوله. ولهذا قيل في اللغة الفرنسية ” الأسلوب هو الرجل نفسه”« Le style est l’homme même ».
وتتصل بالموضوع الذي تفضلتِ بإثارته، مسألةُ الغموض. والغموضُ إمّا مقصود وإمّا غير مقصود. والأول يلجأ إليه الشعراء لإضفاء التأويلات العديدة على نصوصهم. فالتأويلُ يمنح الشعرَ حياةً متجددةً، إذ يهبهُ معنىً فريداً عند كلِّ تأويل. ولهذا قال الشاعر المعاصر أدونيس:
غموضاً، حيثُ الغموضُ أن تحيا،
وضوحاً، حيثُ الوضوحُ أن تموت.
أما الغموض غير المقصود، فمعظمه ضارٌ يعرقل الفهم. ومن خبرتي في الترجمة، أن النصَّ الغامض في اللغة المنقول إليها، ناتجٌ من عدمِ فهمِ المُترجِم النصَّ في اللغة الأصل. وفي الكتابة الإبداعية، ثمَّةَ أسبابٌ عديدة لهذا النوع من الغموض. وقد ظهرت كتب كثيرة لمعالجة أنواع الغموض وأسبابها، لعلَّ أشهرها كتابُ الشاعر الناقد البريطاني وليم أمبسون “أنواع الغموض السبعة“. William Empson. Seven Types of Ambiguity
ومن المسائل المتصلة بوضوحِ اللغة، مسالة “مقروئية النص“، التي تسهم فيها عوامل عديدة، من أبسطها، استخدامُ الشكل الضروري(الحركات)؛ واستعمالُ علامات التنقيط (النقطة، والفاصلة، والفاصلة المنقوطة، وعلامات الاستفهام والتعجب والاقتباس، إلخ.)، وتقسيمُ النصِّ إلى فقراتٍ بحسب الأفكار التي تتناولها؛ وغير ذلك.
ولهذا كلِّه، فإنَّ الكتابةَ الإبداعيةً مسارٌ دراسيٌّ في الجامعات الأمريكية الكبرى، يدرسه الراغبون في امتهان الكتابة (الشعر، الرواية، القصة، المسرحية، المقالة، النقد، إلخ..). ويتصدّى لتدريسه المشهورون من الأدباء والنقَّاد حتّى لو لم يحصلوا على شهادة الدكتوراه، الضرورية للتدريس في تلك الجامعات. فهم يدرِّسون طلابهم من خبراتِهم في الكتابة التي أوصلتهم إلى الشهرة.
والرائع في سؤالكِ أنكِ حدّدتِ مهمّة الكاتب في نقطتين أساسيتين هما: إمتاع القارئ، وتثقيفه (أي تزويده بالمعرفة). وهذا ما ذهب إليه الأديب الفيلسوف أبو حيان التوحيدي من أعلام القرن الرابع الهجري، فجعل عنوانَ أحد كتبه ” الإمتاع والمؤانسة”. وثمة خطأ شائع في فهم هذا العنوان إذ تُفهَم “المؤانسة” في المعنى الشائع، أي الأُنس والطرب والترفيه، على حين أن أبا حيان التوحيدي قصد بـ “المؤانسة ” المذاكرة المعرفية. فللفعل (أَنَسَ) معانٍ عدّة منها، ( أَبصَرَ ورأى وعَلِمَ).
فقد ورد في معجم “لسان العرب“: “استأنَسْتُ: استعلَمْتُ، ومنه…حتى تؤْنِسَ منه الرشدَ، أي تعلمَ منه كمالَ العقل وسدادَ الفعل وحُسنَ التصرُّف.” وهكذا يكون معنى عنوان كتاب أبي حيان: الإمتاع والمعرفة؛ تماماً كما تفضلتِ في سؤالكِ، وليس: الإمتاع والترفيه. فمهمةُ الكاتبِ تجمع بين إمتاع القارئ وإمداده بالثقافة والمعرفة. وهذا ما تلخصه المقولة الفرنسية “”Joindre l’utile à l’agréable“الجمع بين المفيد والممتع. (للتوسع في الموضوع، يُنظَر كتابي “الترجمة وأدواتها“، وكتابي ” الحب والإبداع والجنون: دراسات في طبيعة الكتابة الأدبية“.
النقد في الأصل يتناول الهدم والبناء معاً

المجلة الثقافية الجزائرية: غالباً ما يُحمل النقد دلالات خاطئة كونه مرتبط بفكرة الهدم لا البناء.. برأيك من المسؤول عن توتر العلاقة بين الناقد والمبدع ؟
د. علي القاسمي: “نقدُ الأدب” مصطلحٌ أُخِذَ مجازاً من مصطلح ” نقدُ العملة” الذي كان يعني النظرَ في العملة الفضية أو الذهبية وتمييزها، ومعرفةَ رديئها من جيّدها. وهكذا فالنقد الأدبي يعني النظرَ في النصِّ وإضاءته بتفسير الناقد وفكره، لتبيان ما فيه من مواطنِ الجمال، وكذلك المواضع التي أخفقَ فيها صاحبُ النص.
فالنقد في الأصل يتناول الهدم والبناء معاً. فكان كثيرٌ من نقّادِ الشعرِ العربِ القدامى، مثلاً، يضعون أيديهم على السرقات الشعرية، والاختلالات التي نالت من الوزن والقافية في القصيدة، ويقترحون الصيغَ الصحيحة، في نظرهم. بيدَ أنَّ نظريات النقد الحديثة ومناهجه، ركّزت أكثر على إعطاءِ الأولوية لإبراز جماليات النصِّ، من أجل تصعيد لذَّة القراءة لدى المتلقي.
وفي الوقت الحاضر، وبشكل عام، لا يتناول الناقد نصاً أدبياً بالدراسة، ما لم تكن هناك علاقة ودية بين الناقد والمبدع، أو بين الناقد والنتاج الأدبي لذلك المبدع. (للتوسع في الموضوع، يُنظَر كتابي ” مفاهيم الثقافة العربية” ط2، وكتابي ” النور والعتمة: إشكالية الحرية في الأدب العربي“.
الحوار والمناظرة من وسائل الوصول إلى الحقِّ والحقيقة

المجلة الثقافية الجزائرية: هل مازلنا نفتقد هذا الحوار بيننا وبين الآخر المخالف لنا في الرأي؟ في هذه الحالة كيف نؤسس لعلاقة سليمة بين الناقد والكاتب بعيداً عن استعراض الذات ونفي تعب كل منهما؟
د. علي القاسمي: إن أدب الحوار، والتسامح، وتفهّم رأي الآخر، والجنوح إلى السلم، جميعها تعتمد على الأسرة والمدرسة والثقافة عموماً. والعلاقة بين الناقد والكاتب لا تخرج عن هذا الإطار. ففي ثقافتنا العربية الإسلامية تقاليدُ حميدةٌ في أدبِ الحوار والمناظرة، لأنهما من وسائل الوصول إلى الحقِّ والحقيقة. فكان الإمام الشافعي يقول: “ما ناظرتُ أحداً قط فأحببتُ أن يُخطئ. وما كلَّمتُ أحداً قط وأنا أبالي أن يبيّن الله الحقَّ علي لساني أو على لسانه.”
واختلاف الرأي يمتاز عن الجدل، فالجدل إذا لم يقترن بالأدب واللطف يمسي سلبياً، ولهذا ورد في القرآن الكريم ﴿وجادلهم بالتي هي أحسن﴾. أما التعبير عن الرأي بلين ودماثة فهو إيجابي وقد يقع الاختلاف في الرأي بين غريبيْن أو بين صديقيْن عزيزين أو بين أخويْن شقيقيْن، فلا ينال شيئاً من علاقتهما، بل قد تزداد وثوقاً ومودةً، وهذا ما عبَّرَ عنه الشاعر أحمد شوقي بقوله على لسان قيس بن الملوّح في مسرحية “مجنون ليلى”:
ما الذي أضحكَ مني الظَّبياتِ العامريةْ؟
أ لأني أنا شيعيٌّ وليلى أمويَّةْ؟!
اختلافُ الرأيِّ لا يُفسدُ للودِّ قضيةْ!
(للتوسّع في الموضوع، يُنظر كتابي ” لغة الطفل العربي: دراسات في التخطيط اللغوي وعلم اللغة النفسي“، وكتابي ” الحب والإبداع والجنون: دراسات في طبيعة الكتابة الأدبية“.
الثقافة هي أساس التنمية البشرية

المجلة الثقافية الجزائرية: كمثقف موسوعي مهتم بالتربية والتعليم والآداب الإنسانية دعني أسألك: إلى أي حد يمكن الرهان على الثقافة في استنهاض العقل العربي خصوصاً وأن مجتمعاتنا نشأت أساساً على القمع وأحادية النظرة ورفض التعددية والرأي الآخر؟
د. علي القاسمي: إن كتاب ” التنمية البشرية ” الذي يُصدره سنوياً البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، يبيّن المنهجية التي ينبغي أن تتّبعها الدول الأعضاء في منظَّمة الأُمم المتحدة، لتحقيق التنمية البشرية لشعوبها. كما يشتمل الكتاب على جردٍ شاملٍ وإحصاءاتٍ تتعلَّق بالتنمية في قرابة 190 دولة، ثمَّ يصنِّف هذه الدول حسب واقع التنمية فيها ابتداءً بأرقاها تنميةً إلى أدناها. وتحصل الدولة الأرقى على رقم 1.
ومفهوم التنمية البشرية يختلف عن مفهوم التنمية الاقتصادية الذي كان سائداً في أواسط القرن الماضي، والذي يرمي إلى زيادة الناتج القومي الإجمالي. فالتنميةُ البشرية ترومُ ترقيةَ الإنسان نفسه ورفاهيته. فالإنسان هو الغاية وهو الوسيلة. ويعتمد دليل التنمية البشرية على ثلاثة أبعاد:
1) التعليم وانتشار المعرفة والثقافة، ويقاس التعليم بإحصاءات التمدرس والأمية.
2) الصحة، وتقاس بمتوسط العُمر المتوقع للفرد عند الولادة.
3) الدخل الفردي (وليس الدخل القومي الإجمالي للبلاد)، بل الدخل الفردي الفعلي،الكافي لتحقيق معيشة تليق بالكرامة الإنسانية.
وثمة أبعاد أخرى تهدف إلى تحقق التنمية المستدامة التي تحفظ حقوق الأجيال القادمة في الموارد الطبيعية وعدم استنفادها أو تلويثها. ولهذا عقدت الأمم المتحدة مؤتمراتِ قمَّةٍ لتدارس المناخ. ومن هذه الأبعاد المساواة بين السكان وبين الجنسين، ومراعاة حقوق الإنسان، وغيرها.
وخلاصة القول إنَّ التنمية البشرية ترمي إلى الاستثمار في الإنسان نفسه: في صحَّته وتعليمه ورفاهيته. وتُرينا الدراسات العلمية أنَّ الدولة تستطيع أن تحقق التنمية البشرية خلال جيلين (مدّةُ الجيل حوالي 25 سنة)، إذا اعتمدت التعليم الجيد أساساً لتنميتها.
وفي أواسط القرن الماضي كانت البلدانُ العربية أكثر تقدماً من دول كثيرة في آسيا وإفريقيا. ومن الأمثلة على ذلك سنغافورة التي كانت أفقر دولة في آسيا في الستينيّات من القرن الماضي؛وأصبحت اليوم تحتلُّ المرتبة 5 في التنمية من بين 190دولة. يقول الرئيس لي كوان يو، الذي حقَّق تنمية سنغافورة والذي يُلقَّب بالمعلِّم الذي حوَّل التراب إلى ذهب: “إلى أي درجة كانت سنغافورة الستينيات تعيسة بائسة: فقر ومرض وفساد وجريمة. بيعت مناصب الدولة لمن يدفع، خطف رجال الشرطة الصغيرات لدعارة الأجانب، وقاسموا اللصوص والمومسات فيما يجمعون. احتكر قادة الجيش الأراضي والرز، وباع القضاة أحكامهم. قال الجميع: الإصلاح مستحيل.لكنني توجَّهتُ إلى المعلمين الذين كانوا في بؤس ويزدريهم الجميع، ومنحْتُهم أعلى الأجور وقلت لهم: أنا أبني لكم أجهزة الدولة، وأنتم تبنون لي الإنسان.“
سأل أحد الصحفيين لي كوان يو: ما هو الفرق بين سنغافورة ودول العالم الثالث الآسيوية؟ فأجاب: “الفرق هو أَنّنا نبني المدارس والمكتبات ودور البحث العلمي وهم يبنون المعابد. نحن ننفق موارد الدولة على التعليم، وهم ينفقونها على السلاح. نحن نحارب الفساد من قمة الهرم، وهم يمسكون اللصوص الصغار ولا يقتربون من المفسدين الكبار.“
فالثقافة هي أساس التنمية البشرية. (للتوسع يُنظَر في كتابي “الجامعة والتنمية” وكتابي “حقوق الإنسان بين الشريعة الإسلامية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان“، وكتابي ” السياسة الثقافية في العالم العربي“.
(التراث) تراكمٌ حضاريٌّ وثقافيٌّ

المجلة الثقافية الجزائرية: كثير من المثقفين يرفضون التراث ويعتبرونه سبب التخلف والجهل والإرهاب.. لكن كيف نعطي التراث حقه كامتداد للحاضر والمستقبل؟ كيف نقرأه بموضوعية بعيداً عن التمجيد والتقديس لنتعلم منه؟
د. علي القاسمي: يعني “التُّراث” باللغة العربية ما يخلِّفه الميت لورثته من تركةٍ ،سواء أكانت تلك التركة مالاً أو مجداً أو عقيدةً أو علماً أو فكراً. وفي أثناء ما يُسمى بالنهضة العربية في القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، حاول المثقَّفون العرب في المشرق إحياءَ التراث الفكري والثقافي العربي، في سعيهم إلى إيجاد هُويةٍ عربيةٍ مشتركة ،تُمكِّن من إقامةِ أُمّةٍ عربيةٍ موحَّدةٍ مستقلَّةٍ عن الإمبراطورية العثمانية.
أخذ استعمال لفظ “التراث” في القرن العشرين يدلّ على “ما ورثه العرب عن أسلافهم من ثقافة وحضارة” وراح اسم “التراث” يختلف في دلالته الخاصَّة عن اسميْن آخريْن مشتقَّيْن من الفعل (وَرِثَ) كذلك،هما “الإرث” و”الميراث“،إذ إنَّهما صارا يشيران إلى نصيب كلِّ فردٍ من تركة الميّت فهما يقتضيان وفاةَ الأب وحلول الابن محلَّه، في حين أنَّ “التراث“، في دلالته الحديثة يشير إلى الإرث الفكري والثقافي الذي وصلنا من آبائنا وأسلافنا على مرِّ العصور، والذي ما يزال فاعل في ثقافتنا السائدة. وهكذا، فإذا كان”الإرث أو الميراث“المادّي يتطلَّب موتَ الأب أوَّلاً، فإنَّ “التراث” الفكري والحضاري يعني حضور الأب في الابن،واستمرار الماضي في الحاضر.
فـ (التراث) تراكمٌ حضاريٌّ وثقافيٌّ ينتقل عبر الأجيال والقرون عن طريق اللغة والمحاكاة والتقليد، ويشمل العناصر التالية:
ــــ معارف (العلوم الإنسانية والعلوم الأساسية والطبيعية)
ـــ قِيَم (أنماط تفكير وسلوك،وعادات ومُثُل)
ـــ نُظُم ومؤسَّسات ( الأسرة،المسجد،المدرسة،الأوقاف،الخلافة).
ــــ إبداع وصنع: (الغناء والموسيقى والتراث الشعبي، والفنون المعمارية والزخرفية والتصويرية).
مرَّ التراث العربي الإسلامي بعصورٍ عديدة، منها المتقدِّمة، ومنها المتخلِّفة التي يُطلق عليها “عصر الانحطاط“، وأفرزت لنا هذه العصور خليطاً من التراث الجيّد والسيئ. وعلينا التمييز بين النوعيْن، والأخذ بالتراث الذي يتلاءم مع ما يُسهم في تقدّم ثقافتنا في الحاضر والمستقبل.ولهذا السبب دعا بعض المفكرين العرب مثل اللبناني حسين مروة، والمصري حسن حنفي والجزائري محمد أركون والمغربي محمد عابد الجابري، إلى القطيعة مع التراث. وطبعاً يقصدون بذلك القطيعة مع الجوانب الرديئة من التراث. فبعض عناصرِ التراث لا يمكن القطيعة معها بسهولة، مثل اللغة التي تنقلُ التراث من جيل إلى جيل وتتطوَّر بتطوُّر الناطقين بها، ومثل الأخلاق الحميدة كالصدق والوفاء والإخلاص في العمل والإبداع (الاجتهاد)، من دون أن تحدث تلك القطيعة خللاً كبيراً في سلوكنا وشخصيتنا ومجتمعنا. (للتوسع يُنظَر في كتابي “التراث العربي الإسلامي: تساؤلات وتأملات“).
“معجم الاستشهادات” يخدم جمهوراً مخصوصاً
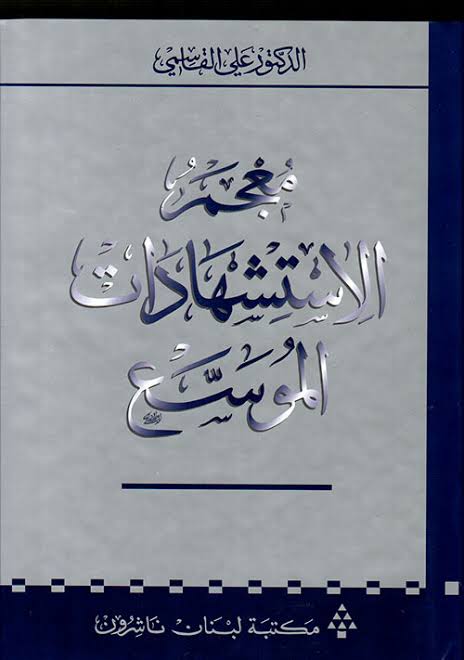
المجلة الثقافية الجزائرية: “معجم الاستشهادات” صدر بعدة طبعات باعتباره إضافة مهمة للغة الضاد وخلاصة مبوبة للفكر العربي وقيمه…. لكن لماذا عجزت المعاجم عن المواكبة والتطور؟ وما سب عزوف القارئ العربي عن هذه الذخيرة اللغوية؟
د. علي القاسمي: لقد جاء سؤالك الكريم في الوقت المناسب، وهو سؤالٌ يتمتع بأهمية خاصة. فقد جرت، قبل ثلاثة أسابيع، مناقشة رسالة ماستر في جامعة مولود معمري ــــ تيزي وزوــــ قدّمها الطالب الجزائري الأستاذ حكيم شاوش، بإشراف أستاذه العالِم لجزائري أخي الدكتور صالح بلعيد، وعنوانها “معجم الاستشهادات الموسَّع أنموذجاً، دراسة وصفية تحليلية“، وأُجيزت بدرجة مشرّف جداً.
ومعجم الاستشهادات، هو كتاب يضم الأقوال، والأمثال، والحِكم، الشعرية والنثرية وتلك المقتبسة من القرآن أو الكتب المقدسة، والأحاديث النبوية، التي يستشهد بها المتحدِّث أو الخطيب في كلامه، أو يستشهد بها الكاتب أو المؤلف في نصوصه، ليُكسبَ رأيَهُ قوةً وصلابةً، من أجل إقناع المستمع أو القارئ بالرأي الذي يُدلي به. وتُرتَّب هذه الاستشهادات بطرائق مختلفة: بحسب موضوعاتها، أو تاريخها، أو مصادرها، أو تخصُّصاتها، أو غير ذلك.
ولأن هذه المعاجم تقدِّم خلاصة مبوبة لفكر الأمَّة، كما تفضلتِ، فإن اللغات العالمية كالإنجيلزية والفرنسية والألمانية تمتلك أنواعاً عديدةً منها. مثل معجم الاستشهادات الموسيقية، ومعجم الاستشهادات الاقتصادية، ومعجم الاستشهادات الشعرية، إلخ. ففي اللغة الإنجليزية نجد حالياً أكثر من مئة معجم للاستشهادات، وفي اللغة الفرنسية ما يربو على ثمانين معجماً. وعلى الرغم من أن اللغة العربية هي أم اللغات جميعاً، ولصناعة المعجم فيها تراث ناصع كبير، فإنها لم تعرف معاجم الاستشهادات القرن الميلادي العشرين؛ وإنما تملك عدداً لا بأس به من كتب الأمثال.
ولهذه الظاهرة أسبابها التي شرحتها في مقدمة كتابي “معجم الاستشهادات” الذي صدر في بيروت سنة 2001. ثم أصدرتُ كتابي ” معجم الاستشهادات الموسع ” سنة 2008، وكتابي “معجم الاستشهادات الوجيز للطلاب” سنة 2014. ولكلِّ واحد من هذه المعاجم منهجية مختلفة، وطريقة ترتيب متباينة، ويخدم جمهوراً مخصوصاً ويستجيب لاحتياجاته.
وقد بيّنتُ في مقدمة الأوّل من هذه المعاجم، كيفية تصنيف معاجم الاستشهادات، وأغراضها، ومناهجها، وطرائق ترتيبها، بحيث يستطيع مَن يرغب، تأليفَ هذا النوع من المعاجم على أُسسٍ علميةٍ معجمية.
ثقافتنا ستختلف بعد كورونا

المجلة الثقافية الجزائرية: جائحة كورونا أضافت سبباً آخر لحالة التراجع الثقافي الذي نعيشه في مجتمعاتنا.. وجعلتنا نتساءل عن حصن الثقافة، عن هاجس المعرفة،عن إمكانيات التطور.. برأيك إلى أي حد يستطيع المثقف تجاوز هذا الظرف بالاستفادة من وسائل الاتصال الحديثة؟ وهل ما زال التفاعل بينه وبين المتلقي ممكناً؟
د. علي القاسمي: حصل كسادُ الثقافةِ بسبب جائحة الكورونا في البلدان المتخلّفة مثل بلداننا، مع الأسف ( ومن نباهتكِ، قولك:” التراجع الثقافي في مجتمعاتنا“) . أمّا في البلدان المتقدِّمة فقد نتج عن هذه الجائحة وتداعياتها إقبال أكثر على القراءة والثقافة. ففي بداية الجائحة، عندما اتّجهت نيةُ دولِ العالم إلى فرض الحجر الصحي، هرع المواطنون في الدول المتقدِّمة إلى المكتبات لاقتناء الكتب بوصفها أفضل وسيلة لتمضية الوقت في المنزل، حتى أن الصحافة الأوربية نقلت أنباء نفاد الكتب من أغلب الرفوف في مكتبات بيع المطبوعات. أما في البلدان المتخلفة، فقد هجم المواطن على مخازن الأطعمة لشراء المواد الغذائية وتخزين الطعام في منازلهم.
القراءة أساس الثقافة والمعرفة والعلم. وعادة القراءة في البلدان العربية اندثرت في عصر الانحطاط، وما زالت مندثرة، ولم تعمل مدارسنا الحديثة على غرسها في نفوس أطفالنا. والأنكى من ذلك، أننا أمسينا نعتبرُ حمل الكتاب في الطريق عيباً وعاراً؛ على حين أنك في أوربا لا ترى في وسائل المواصلات، وفي الحدائق، والمقاهي، مَن لا يقرأ، في كتاب أو حاسوب. فأوربا تنتج من الكتب (الورقية والإلكترونية) أعداداً أكثر بكثير من أرغفة الخبز.
بلى؛ يحفظ أطفالنا في المدارس عن ظهر قلب قصائد في مدح الكتاب وقيمة القراءة، مثل قول المتنبي:
أعزُّ مكانٍ في الدُّنى سرجُ سابِحٍ … وخَيرُ جَليسٍ في الزَّمانِ كتابُ
ولكنَّ حفظ هذا البيتِ وأمثاله لا يكوِّن لديهم عادة القراءة، كما أنه لا يعلّمهم ركوب الخيل الذي ورد في صدر البيت. فتكوينُ العادات يحتاج إلى تكرارها كثيراً مدَّة كافية حتى تُصبح من مهام العقل الباطن (اللاواعي)، وتغدو حاجة نفسيّة ماسة لا يرتاح الفرد إنْ لم يمارسها. فغرسُ عادة القراءة في نفوس الأطفال في مدارسنا يحتاج إلى دروس نظرية وتطبيقات عملية. فالدروس تقنعهم بفوائد القراءة للفرد والمجتمع. والتطبيقات هي تمرينات على القراءة الجهرية والهمسية، وتكرار هذه التمرينات يومياً. وتتضمن أن يقوم التلميذ في المنزل بقراءة كتابٍ مناسبٍ في كلِّ أسبوع على الأقل. مع متابعة حثيثة من المعلّم لتلك القراءة.
ومن ناحية أخرى، فإنَّ جائحةَ كورونا أدَّت إلى تطوّر في البرامج الحاسوبية، وتكنولوجيا وسائل الاتصال، لتوفير المعلومات المدرسية للأطفال في منازلهم عن طريقها، وتفادي التجمعات التي تساعد على انتشار هذا الفيروس. ويقيناً أن عالمنا وثقافتنا ومدارسنا وجامعاتنا، ستختلف من حيث المناهج والطرائق والوسائل بعد الجائحة، عما كانت عليها قبلها.
وستبقى بلداننا متخلِّفة ما بقيت مدارسنا تعلِّم المنهج المدرسي فقط، ولا تغرس عادة القراءة في نفوس الأطفال، بحيث يشعر الفرد، منهم ومنا، بأنه لا يحيا حياته ما لم يقرأ طوال أوقات فراغه، ويكتسب الثقافة والمعرفة. وإلا فسنظل قوماً نعيش لنأكل.
(للتوسع في الموضوع، يُنظَر:
ـــ الدكتور محمود محمد علي. جائحة كورونا، بين نظرية المؤامرة وعفوية الطبيعة (الإسكندرية: دار الوفاء للطباعة والنشر، 2021)
ــــ الدكتور طالب الخفاجي. العقل الخبيث: كيفية تحقيق السعادة والتحكُّم بالعقل الباطن. ترجمة: د.علي القاسمي ( الرياض: دار التوبة للنشر، 2019).
الرواية العربية حققت تقدُّماً ملحوظاً لكنَّه محدود

المجلة الثقافية الجزائرية: الرواية العربية المعاصرة غاصت في خفايا التاريخ وطرقت كل المواضيع الاجتماعية غالباً. برأيك إلى أي حد نجح الروائيون في عرض تمثيل سردي مغاير عن السرد التقليدي؟
د. علي القاسمي: لا شك في أن الرواية العربية حققت تقدُّماً ملحوظاً. ولكنَّه يبقى محدوداً، لثلاثة أسباب:
السبب الأول، لا يوجد أدباء عرب محترفون؛ كلُّنا هواة. فنحن نعمل في الصحافة أو التعليم أو ما إلى ذلك لنكسب عيشنا، وفي أوقات فراغنا، إذا بقي لنا وقتُ فراغٍ بعد القيام بواجباتنا في العمل والبيت العائلي، ندوِّن ما قد يلّح علينا من شعر أو نثر.
وإذا أنتجنا كتاباً تواجهنا مشكلة النشر. فليس هنالك ناشرون في العالم العربي، بل معظمهم تجّار كتب، يجهلون، أو يتجاهلون شيئاً اسمه حقوق المؤلِّف. فالكاتب العربي الذي يريد أن ينشر كتابه الأول أو كتبه الأولى، يواجه ما يُشبه الابتزاز. فالناشرون يطلبون منه أن يدفع ألف أو ألفي دولار. وأكثر الناشرين لا يعرفون شيئاً اسمه العقد وما يجوز وما لا يجوز النصُّ عليه فيه. أرسلتُ ذات مرّة رواية مترجمة إلى ناشر عراقي في دمشق لاستطلاع رأيه في إمكان نشرها، نشرها دون أن نتفق أولاً. وعندما طالبته بحقوق الترجمة. أخبرني بأنها حسب عدد الكلمات عندهم، وسأحصل على 25 دولاراً لا غير. فلم أكتب إليه بعد ذلك حفاظاً على وقتي. ثمَّ انتقل هذا الناشر إلى العراق، وأصدرت داره طبعة جديدة من
ترجمتي لتلك الرواية. فنبَّهتُ تلك الدار بأنها فعلت ذلك بدون أن نتفق أولا على ذلك. أجابت الدار بأنَّ ملفّاتها بقيت في دمشق ويصعب معرفة الاتفاق الأصلي. وبعد مراسلات طويلة أخبرتهم فيها بأنه لا يوجد عقد بخصوص تلك الرواية، بعثوا إليَّ بعقد عجيب غريب مُدَّته 99 سنة، مقابل مبلغ زهيد. ولم أسمع بعقد مُدَّته 99 سنة إلا في عقود الإيجار الطويل في بريطانيا، الذي طبَّقت مثله مع الصين عند استعمارها هونغ كونغ.
السبب الثاني، إن الذين يمارسون الكتابة الأدبية في العالم العربي، لم يتعلَّموا أصول الكتابة الأدبية. ففي الجامعات الأمريكية الكبرى، هناك دروس ينخرط فيها ذوي المواهب، ليتعلَّموا تقنيات كتابة الشعر، أو القصة القصيرة، أو الرواية، أو المسرحية، أو غيرها، تماماً كما يتعلَّم الراغبون في امتهان الفنون التشكيلية، تقنيات الرسم، أو النحت. وعادةً ما تستعين تلك الجامعات بالشعراء المرموقين، والقصاصين البارزين، والروائيين الأعلام، لإعطاء تلك الدروس المتخصِّصة. وهؤلاء هم الأساتذة الوحيدون الذين يُعفَون من شرط حصولهم على شهادة الدكتوراه المطلوبة للتعليم في الجامعة. فإذا وجِد قاص مشهور، مثلاً، حقق نجاحات مثالية في كتابة القصة القصيرة، ولم يحصل على أكثر من شهادة المدرسة الثانوية، فإن بعض الجامعات ترغب في استخدامه أستاذاً ليعلّم طلابه التقنيات التي طوّرها، والتجارب التي أجراها، وأثبتت نجاعتها في التأثير في المتلقي.
السبب الثالث، إن معظم الحكومات الشمولية في العالم العربي لا تشجع الثقافة، إنْ لم نقُل تحاربها. أو كما قال أحد زعما ء النازية الألمان، غوبلز: “عندما أسمع كلمة ثقافة، أضع يدي على مسدسي“. فمثل تلك الحكومات تعمل على تجهيل شعوبها ليسهل تنويمها وسرقتها. أما الدول التي ترعى الثقافة وتشجعها، فتكافئ المثقَّفين بطرق متعدِّدة، وتيسّر لهم إنجاز مشاريعهم الفكرية. ففيها إقامات على الشواطئ، والمناطق الجبلية ذات المناظر الخلابة، مجهزة بالمكتبات والمطاعم والملاعب، تستقبل الباحثين والكتّاب والأدباء والفنانين، لثلاثة أشهر، أو ستة شهور، أو سنة كاملة ضيوفاً على الدولة؛ ليتمكّنوا من استكمال بحوثهم أو كتبهم.(تذكَّري أنَّ الأدباء والمفكرين، إبّان ازدهار الثقافة العربية الإسلامية، يحصلون على رواتب شهرية، ويحلّون ضيوفاً على الخليفة أو الوزراء أو الولاة أو العمّال، ويجرون مناظراتهم الفكرية بحضورهم، ويستفيدون من مكتباتهم وعطاياهم الجزيلة).
علاقتي بالأدب الجزائري والرواية الجزائرية علاقة خاصّة

المجلة الثقافية الجزائرية: دعني أسألك عن الرواية الجزائرية تحديداً.. كيف ترى تطورها في حدود ما قرأته للروائيين الجزائريين بحكم إقامتك في المغرب لسنوات طويلة؟
د. علي القاسمي: سؤالك الكريم عن الرواية الجزائرية، يحتاج إلى حوارٍ مستقلٍّ. وبصورة عامة، فإنها ــــ في رأيي المتواضع ــــ جزءٌ من الرواية العربية عموماً ذات الجذور في القصص القرآني والسيرة النبوية والمقامات وألف ليلة وليلة وغيرها. وقد تأثرت بظهور الرواية في أوربا في القرن الثامن عشر بفعل انهيار طبقة الإقطاع الأوربية، وبفضل فكر عصر الأنوار وظهور الطبقة البرجوازية الوسطى في أوربا. ولا نغفل آثار الروايات العربية التي ظهرت في المشرق والمغرب أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن العشرين، خاصة روايات جورجي زيدان التاريخية، ذات الانتشار الواسع.وهكذا فالرواية الجزائرية متحت من ثلاثة روافد ثقافية: الرافد الجزائري الوطني، والرافد الأدبي العربي، والرواية الفرنسية المتطوّرة.
بيد أن علاقتي الشخصية بالأدب الجزائري عموماً، والرواية الجزائرية خصوصاً، علاقة خاصّة، لأنني أنتمي إلى جيل يُطلَق عليه “جيل الثورة الجزائرية”. فعندما كنتُ طالباً في دار المعلمين العالية بجامعة بغداد (من 1957ــــ1961) كانت الثورة الجزائرية مستعرة، وكانت الدار تعج باللقاءات والمظاهرات والأدب شعراً ونثراً تأييداً للثورة الجزائرية. والأكثر من ذلك أنني في تلك الفترة كنتُ أعمل مترجماً ومحرراً لنشرة إخبارية في وكالة الأنباء العراقية المسؤولة عن إعداد النشرات الإخبارية لدار الإذاعة والتلفزة العراقية، كلَّ ساعتين. وكانت تعليماتُ رؤسائنا ألا تخلو نشرة من النشرات الإخبارية عن أنباء الثورة الجزائرية لتأجيج مشاعر المستمعين النبيلة وحشد تأييدهم للثورة. ولهذا كنتُ أقرأ جميع ما يتعلّق بالجزائر في صحفنا الوطنية ووكالات الأنباء العالمية التي كانت تصلنا بالبرق الطابع (التلبرنتر) في الوكالة، بما في ذلك الأدب الجزائري، حتى مراجعات الروايات المكتوبة بالفرنسية لكتّاب جزائريين مثل محمد ديب ومالك حداد ومولود فرعون ومولود معمري وكاتب ياسين وآسيا جبار.
وبعد نجاح الثورة المجيدة واستقلال الجزائر، بقيتُ أتابع الرواية الجزائرية باللغة العربية حيث تطوّرت تطوراً ملحوظاً على يد الأجيال الصاعدة التي تشبّعت بالثقافة العربية الإسلامية، وتناولت آمالها وآلامها وإحباطاتها. ولعل رواية عبد الحميد بن هدوقة “ريح الجنوب” (1971) التي حوّلتها السينما الجزائرية إلى فيلمٍ، تشكِّل علامةً فارقة في نضوج تقنيات الرواية الجزائرية الحديثة.
وإذا أُتيحت لك الفرصة للاطلاع على بعض دراساتي مثل تلكتتناول “الإمام عبد الحميد بن باديس، رائد النهضة العربية الإسلامية في الجزائر” أو مراجعتي لكتاب صديقي المجاهد عثمان سعدي ” الثورة الجزائرية في الشعر العراقي” ستجدين الأدب الجزائري ماثلاً فيهما. وحتى في روايتي السير ذاتية “مرافئ الحب السبعة“، ستجدين الحديث عن جيلي وعن بعض الروايات الجزائرية مثل روايات الشاعرة الدكتورة أحلام مستغانمي.
(للتوسع في الموضوع: يُنظر كتابي “طرائف الذكريات عن كبار الشخصيات“) وختاماً، أود أن أزجي جزيل الشكر وأخلصه إلى مجلة الثقافة ومحرريها وقرائها الكرام.